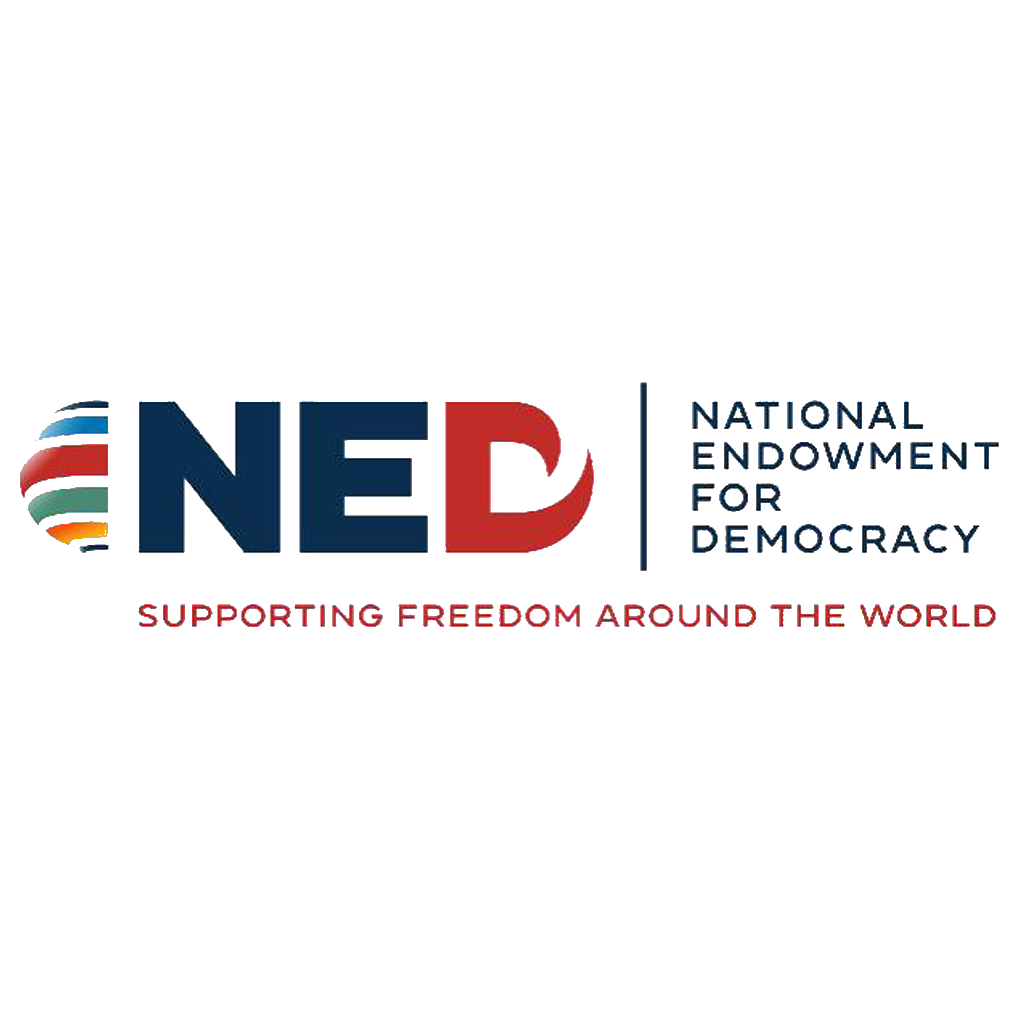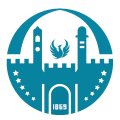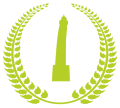موصل تايم
منذ عام 2003، لم تكن عملية تشكيل الحكومات في العراق شأنًا داخليًا خالصًا بقدر ما كانت نتاجًا لتقاطع دوائر النفوذ الدولي والإقليمي، حيث تتداخل الحسابات المحلية مع ضغوط الخارج في صناعة القرار التنفيذي. ومع كل دورة انتخابية، تتكرّر ملامح المشهد ذاته: تحالفات تتشكل داخل بغداد، وقرارات تتبلور خارجها. لكن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن قوى فاعلة داخل الإطار التنسيقي أعادت النقاش إلى الواجهة، بعدما أقرّت بوضوح بوجود “الضغط الخارجي والإقليمي” في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل.
يقول عدي عبد الهادي، عضو الإطار التنسيقي، في حديثه لـ“موصل تايم”، إن “الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل مهمة ومفصلية، والجميع يجمع على ضرورة نجاحها وضمان مستوى عالٍ من الشفافية”. ويضيف أن “هناك حالياً من خمسة إلى ستة مرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، رغم أن الانتخابات لم تُجرَ بعد، لكن بشكل عام، الإطار سيكون له الدور الأبرز في تشكيل الحكومة بغض النظر عن النتائج”. ثم يقرّ بأن “تشكيل الحكومة سيخضع للعديد من التفاصيل، وسيبقى الضغط الخارجي والإقليمي حاضراً، لكن الاختيار النهائي سيكون لقوى الإطار وبقية القوى المشاركة في التحالف لتحديد آلية تشكيل الحكومة”.
هذا الاعتراف، الذي جاء من داخل إحدى الكتل الأشد تأثيرًا في المعادلة السياسية، يسلّط الضوء على ظاهرة “التدخّل الممنهج” في تشكيل السلطات التنفيذية، والتي لم تعد استثناءً بل تحوّلت إلى جزء من النمط العام لتشكيل الحكومات في العراق. تحوّل النفوذ الخارجي من عامل طارئ إلى عنصر ثابت في عملية إنتاج القرار، سواء عبر دعم مرشحين بعينهم، أو من خلال التأثير على مسارات التفاوض بين الكتل.
يلاحظ باحثون في الشؤون السياسية أن التدخل الخارجي في العراق مرّ بمراحل متعاقبة، بدأت بالتأثير العسكري المباشر بعد عام 2003، مرورًا بالتحكم بالعملية الانتخابية من خلال التمويل والتحالفات، وصولًا إلى مرحلة النفوذ “الناعم” الذي يعمل داخل الأطر القانونية والسياسية. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن القوى الإقليمية والدولية لم تعد تعتمد على الضغط العسكري أو التلويح بالقوة، بل على أدوات أكثر تعقيدًا مثل العلاقات الاقتصادية، والدعم الإعلامي، والتنسيق الحزبي غير المعلن.
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث في العلاقات الاستراتيجية علي الجبوري لـ“موصل تايم” أن ما يحدث اليوم هو “تراجع في التدخلات الخارجية من حيث الشكل، لكنه لا يعني نهايتها، بل تحوّلها إلى أدوات أكثر هدوءًا وفعالية”. ويضيف أن “العراق ما يزال ساحة تأثير متعددة المستويات، إذ تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى مع حسابات القوى المحلية”.
هذه المقاربة تبرز التحول من السيطرة المباشرة إلى ما يمكن وصفه بـ“الهندسة السياسية”، حيث تدار عملية اختيار رؤساء الحكومات عبر شبكة مصالح متداخلة تجمع بين الخارج والداخل. ويتضح من خلال هذا النمط أن الاستقلالية السياسية في العراق ليست غائبة تمامًا، لكنها محدودة بإطار توازنات إقليمية ودولية يصعب تجاوزها.
تحليل مسار تشكيل الحكومات منذ 2003 يكشف عن نمط مستمر من “التدخّل المتقبّل”، إذ باتت القوى السياسية تتعامل مع الضغوط الخارجية بوصفها جزءًا من قواعد اللعبة، لا خرقًا لها. فالتدخل الذي كان يُدان في السنوات الأولى بعد التغيير، أصبح اليوم يُدار بتنسيق محسوب، ما يعكس انتقاله من خانة “الرفض” إلى خانة “التطبيع”.
وتشير تقارير بحثية إلى أن العراق أصبح نموذجًا لما يُعرف بـ“السيادة التفاوضية”، حيث تتوزع مراكز التأثير بين الداخل والخارج، ويجري إنتاج القرار النهائي عبر مزيج من الرغبة المحلية والموافقة الدولية. وفي هذا النموذج، لا يُلغى دور الداخل، لكنه يُعاد تشكيله وفق ميزان الضغط الخارجي.
وتُظهر التصريحات السياسية في بغداد خلال السنوات الأخيرة، أن الأطراف المحلية غالبًا ما تتعامل مع “التفاهمات الخارجية” كواقع لا يمكن تجاوزه، ما يفسر ارتفاع وتيرة اللقاءات والمشاورات بين القوى السياسية وممثلي الدول المؤثرة عقب كل انتخابات. ومع ذلك، فإن الاعتراف بوجود “الضغط الخارجي” لا يعني بالضرورة الخضوع له، بل يشير إلى أن التوازن الداخلي ما زال هشًا، وأن السيادة ما زالت قيد التفاوض.
لا يقتصر أثر التدخل الخارجي على تشكيل الحكومة فحسب، بل يمتد إلى إعادة توزيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة. فعندما تُصاغ التحالفات وفق معايير الدعم الإقليمي أو الرضا الدولي، فإن بنية النظام السياسي نفسها تتأثر. ومن أبرز نتائج هذا النمط، بروز ما يمكن تسميته بـ“الطبقة السياسية المحصّنة”، وهي مجموعة من القوى والأفراد الذين يتمتعون بدعم مزدوج: داخلي من جمهورهم، وخارجي من شبكات المصالح. هذه الطبقة تمتلك قدرة عالية على البقاء في السلطة حتى مع تبدّل الظروف، لأنها تستمدّ قوتها من توازن الخارج لا من تنافس الداخل.
وبحسب قراءات بحثية في النظم السياسية الانتقالية، فإن هذا النوع من البُنى يؤدي إلى تآكل فكرة المحاسبة، إذ يصبح بعض الفاعلين السياسيين خارج نطاق المساءلة الفعلية، سواء بفعل الحصانة القانونية أو بفعل الدعم الدولي الذي يصعب كسر تأثيره.
يُظهر المسار العام لتشكيل الحكومات العراقية أن النفوذ الخارجي لم يعد يُمارس عبر أدوات السيطرة التقليدية، بل من خلال ما يمكن وصفه بـ“التأثير البنيوي الهادئ”، الذي يعمل في ظل تفاهمات مستمرة بين الداخل والخارج. التصريح الصادر عن عضو الإطار التنسيقي يُعيد التذكير بهذه الحقيقة، من خلال الاعتراف الصريح بوجود “ضغط خارجي وإقليمي” في مرحلة ما قبل اختيار رئيس الوزراء.
هذا النوع من التصريحات لا يُعدّ إدانة بقدر ما هو انعكاس لواقع سياسي معقد، يعيش فيه العراق ضمن شبكة من التوازنات التي لم ينجح بعد في فكّ ارتباطها. وإذا كان النفوذ الخارجي حقيقة يصعب إنكارها، فإن الحدّ من أثره يتطلّب بناء منظومة سياسية أكثر تماسكًا، تقوم على استقلالية المؤسسات، وتنويع العلاقات الدولية، وتكريس مبدأ الشفافية في التحالفات والتمويل.
يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للعراق أن يصل إلى مرحلة يكون فيها تشكيل الحكومة نتاجًا لإرادة وطنية خالصة؟ الجواب، وفق معظم التحليلات، لا يتعلق بإلغاء التدخلات، بل بقدرة الدولة على إدارة التوازنات من موقع الفاعل لا المتأثر. فالتحرّر من النفوذ لا يتحقق بالقطيعة مع الخارج، بل بإعادة تعريف العلاقة معه على أساس المصلحة الوطنية لا الوصاية السياسية، بحسب مراقبين.